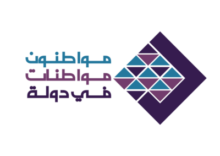مقال من كتابة آلان علم الدين، نشر في جريدة الأخبار.
في فلسطين، تدعو السلطة حماس لتسليم سلاحها لها. وفي سوريا، يرتكب النظام المجازر بحق شعبه. وفي لبنان، تتّخذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيدها. وعلى اختلاف الحالات الثلاث، حجة واحدة: للدولة الحق الحصري في السلاح. لكن هذه الحجة تصطدم بواقعين: الأول أن ليست كل «دولة» دولة. والثاني، أن لا شرعية متأصلة (inherent legitimacy) لأي دولة. ينقد تفكيك المسألة بعض الأساسات الفكرية التي فرضها الاستعمار على ثقافتنا السياسية، ويضع الأساس للمخرج.
ليست كل «دولة» دولة. فهل كانت «الدولة الإسلامية في الشام والعراق» دولة؟ الدولة هي جهاز وظيفي لإدارة شؤون المجتمع. أمّا «دولة فلسطين»، فلا عملة لها، وطاقتها مصدرها الاحتلال، و«حدودها» يديرها الاحتلال. و«دولة سوريا» لا سيادة لها على أرضها المفككة بين سلطات أمر واقع سورية هوياتية واحتلالات إسرائيلية وأميركية وتركية.
و«دولة لبنان» لا تستطيع تأمين الكهرباء والمياه ولا توحيد المنهاج الدراسي ولا سجن رياض سلامة (فهو لم يكن في البيت!) ولا حتى تزفيت الطريق، ناهيك بإبقاء الوزير جورج قرداحي وزيراً أو اتخاذ أبسط القرارات السيادية. فإن كانت هذه الكيانات عاجزة عن إدارة شؤون مجتمعها، كيف تكون «دولاً»؟ وإن قاربنا الموضوع من منظار «احتكار العنف»، هل يمكن القول إن هذه الكيانات الثلاثة تحتكر فعلاً العنف حين يمارس الاحتلال العنف على أراضيها ومجتمعاتها بشكل شبه يومي؟
كما إن لا شرعية متأصلة لأي دولة. فعلى أي سلطة أن تبرر وجودها، إذ إن لا «سلطة» إن لم يرتضها فعلاً طرف من آخر. وأساس هذا الارتضاء، أي التبرير الذي تقدّمه الدولة لسلطتها، هو أساس شرعيتها بعين مجتمعها. بالتالي، الشرعية تُكسب وهي قابلة للنقد. على سبيل المثال، إسرائيل دولة إذ إنها تدير فعلاً شؤون التجمّع الاستيطاني في فلسطين. لكنها دولة احتلال لم تستطِع أن تفرض شرعيتها المزعومة إلا على عدد قليل من سكّان الأرض الأصليين. وهذا ما يثبت أن لا شرعية متأصلة حتى للكيانات التي تستطيع أن تمارس دوراً وظيفياً كدولة. بكلمات أبسط: كون كيان ما «دولة» لا يعني أن علينا الارتضاء به وبحصر السلاح بيده.
لا بد من الإشارة هنا إلى مفهوم أوروبي يعتبر أن الدولة حتماً أمر جيد. فقبل نشوء الدول، كانت المجتمعات الأوروبية خاضعة لسلطات قبلية إقطاعية دعمتها الكنيسة الكاثوليكية عبر مفهوم «الحق الإلهي للملوك» (المعيّنون، طبعاً، من الكنيسة). وهكذا، أدّى نشوء البروتستانتية وتحدّيها لادعاء الكنيسة تمثيل إرادة الله إلى زعزعة الأنظمة السياسية آنذاك، وهذا ما أدّى تباعاً إلى حروب أهلية فتكت بمجتمعات أوروبا على مدى قرون.
وانتهى الأمر باتفاق ويستفاليا التي أقرّت به الكنيسة الكاثوليكية بتغير موازين القوى لصالح البروتستانت مقابل كف هؤلاء عن مخاصمتها سياسياً. وذلك على أساس انتقال أوروبا من منطق الإقطاع إلى منطق الدول، لكل دولة هوية دينية، إمّا كاثوليكية كفرنسا وإيطاليا، أو بروتستانتية كبريطانيا والسويد، أو فيدرالية من الولايات الكاثوليكية والبروتستانتية كألمانيا.
كان لحصر السلاح في يد تلك الدول وقع إيجابي واضح: وقف حمام الدم، أخيراً. لكن نموذج الدولة هذا تضمّن مخاطر عدّة إذ وضع الأساس لشرعية هوياتية للدولة. وبما أن الهوية هي ما يميّزنا عن الآخرين، فإنّ تسييسها على هذا النحو حتّم على هذه الدول معاملة المجموعات الهوياتية الأخرى كـ«آخر». وهكذا أصبحت الدولة كياناً عدوانياً بجوهره، فاضطهدت مواطنيها «المختلفين»، فاسحةً المجال لحركات فاشية استهدفت اليهود كالنازية، ولأخرى ادّعت تمثيل مصالح اليهود كالصهيونية. أمّا اليوم، فتضطهد هذه الدول، التي لم تقم بمراجعة مخاطر شرعيتها الهوياتية، بالتمييز ضد الـ«آخرين» المسلمين أو السود أو السمر الموجودين على أراضيها.
كما إنها قامت بتصدير مفهومها للدولة للمجتمعات التي استعمرتها. فهي، من جهة، توظف الهويات لتفتيت المجتمعات التي تستهدفها، عبر، على سبيل المثال، توفير الدعم للدولة اليهودية في فلسطين وقوى الأمر الواقع السنية والدرزية والكردية في سوريا والنظام الطائفي في لبنان. ومن جهة أخرى، تفرض هيمنة ثقافية تعتبر أن للدولة شرعية متأصلة. لذا نشعر، على سبيل المثال، بممانعة تجاه وصف دولة الاحتلال بالدولة، وكأن الكلمة تشير ضمناً إلى كيان شرعي. فيما نشعر بممانعة تجاه وصف تنظيمات مقاومة بالميليشيا، وكأن الكلمة تشير ضمناً إلى تنظيم فاقد للشرعية. وفضح هذا المفهوم الخطأ ضروري أمام ادعاء «دول» فلسطين وسوريا ولبنان الحق الحصري في السلاح.
إلا أن رفض الشرعية الهوياتية للدولة ورفض اعتبار الشرعية متأصلة في الدولة لا يعنيان رفض مفهوم الدولة. فهناك حاجة، بل حاجة ماسة وملحة، إلى إقامة دول فعلية في بلداننا، أي دول ترسي شرعية وظيفية عبر قدرتها العملية على تمثيل وصون مصالح مجتمعها. ففلسطين ترزح تحت دولة احتلال تحشد السلاح والمال والقدرة الإعلامية والعلاقات الدولية، ومسؤوليتنا العمل على بناء دول تواجه دولة الاحتلال في كل هذه الساحات.
وسوريا مفتتة بين قوى أمر واقع تتشارك، على كل اختلافاتها، منطلقات العدو نفسها التي ترى المجتمعات طوائف ومكونات، ونقيض ذلك هو قيام دولة المواطنة. وفي لبنان، برهن العامان الماضيان، اقتباساً لمشروع «مواطنون ومواطنات في دولة»، أن «الحصرية الطائفية للمقاومة تضع الغايات الوطنية للعمل المقاوم وتضحيات الطائفة نفسها في خطر دائم من النزاع الطائفي المستمر».
وعليه، «إنّ القدرات والموارد العسكرية التي راكمها حزب الله ليست عبئاً على لبنان. بل، إن أُطّرت في مشروع مدني وطني يتعاطى مع المجتمع اللبناني كمجتمع واحد، يمكن أن تصبح موارد داعمة لقيام دولة تحمي أبناءها من المخاطر والتحديات والتدخلات الأجنبية، وأن تصبح نقيضاً للمشروع الصهيوني العنصري والتفتيتي».
ما يُكسب مسعى سياسياً ما شرعيةً ليس كونه مسعى دولة أم مسعى تنظيم، إنما المشروع السياسي الذي يندرج ضمنه. وقد راكم حزب الله رصيداً استثنائياً جراء مقاومة العدو ودحره من جنوبنا عام 2000 ثم الانتصار عليه عام 2006. لكنه هدر جزءاً من هذا الرصيد في سلسلة من الخيارات الخطأ، بما في ذلك خيار تثبيت شرعية النظام الطائفي الاستعماري في لبنان.
بوجه ثنائية «حصر السلاح في يد حزب الله» و«حصر السلاح في يد لا-دولة الطوائف»، ثمة خيار آخر: إرساء شرعية دولة قادرة على حماية مجتمعها من العدو ومن التفتت، بالسلاح وغير السلاح. والدفع باتجاه هذا الخيار ليس مسؤولية قيادة حزب الله فحسب، بل مسؤولية كل كادر وكل عضو فيه، ومسؤولية سائر المواطنين اللبنانيين.