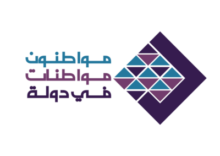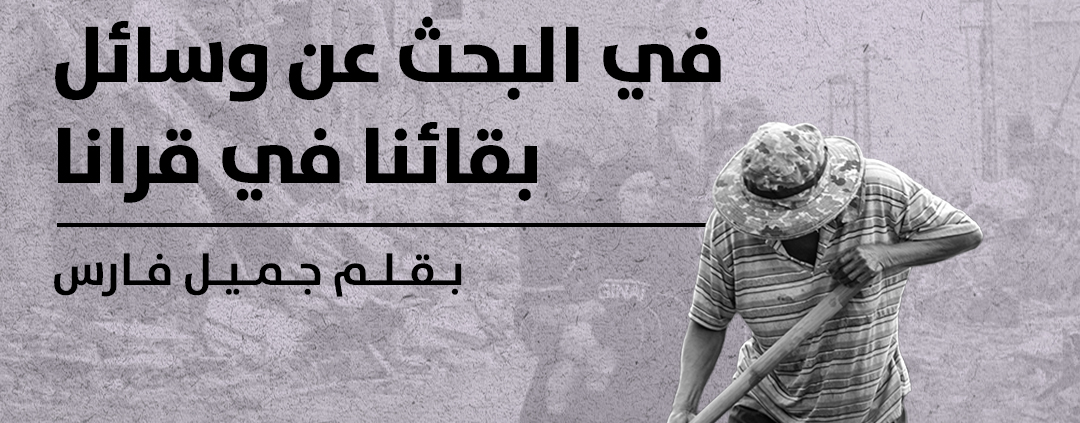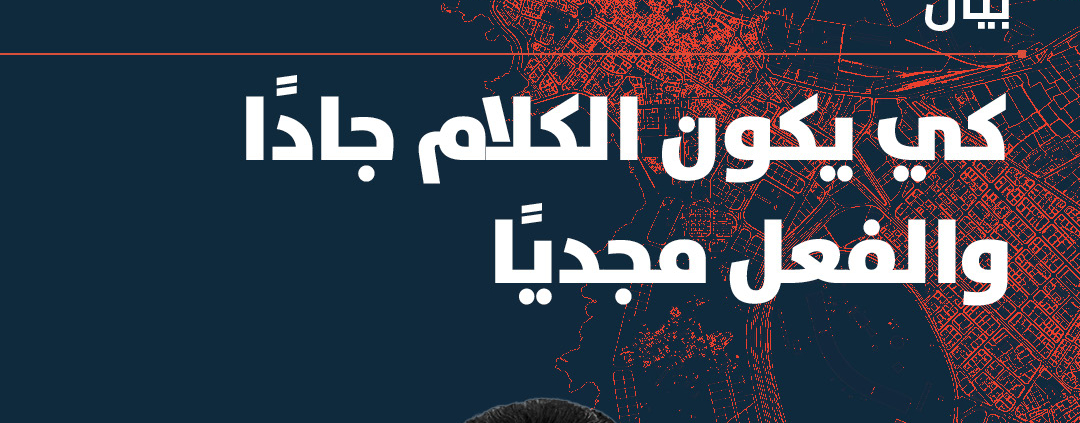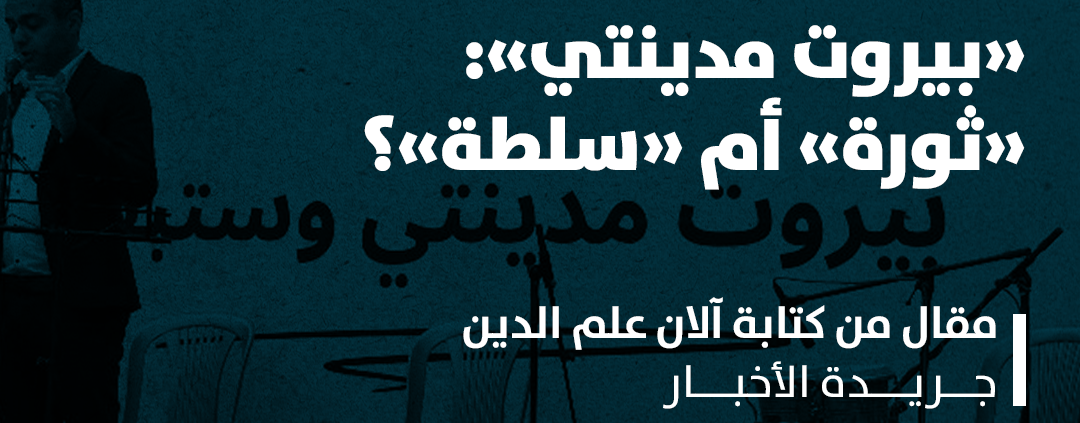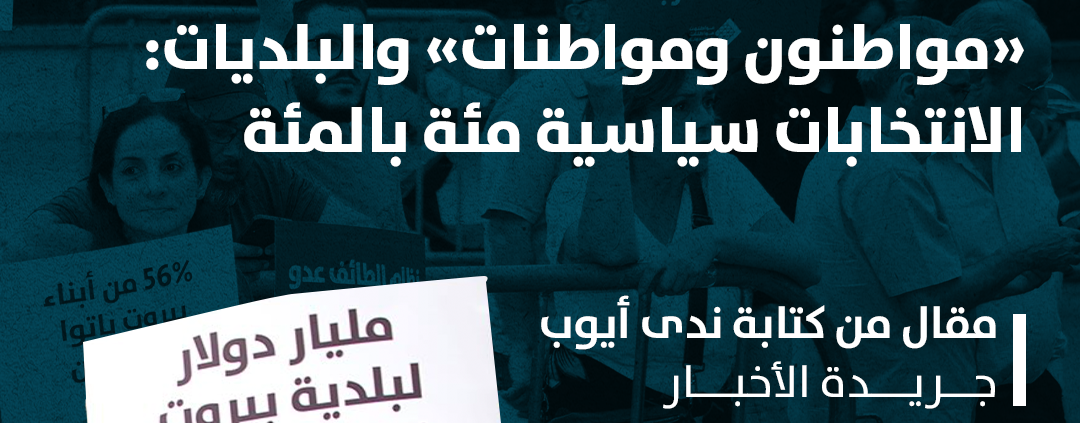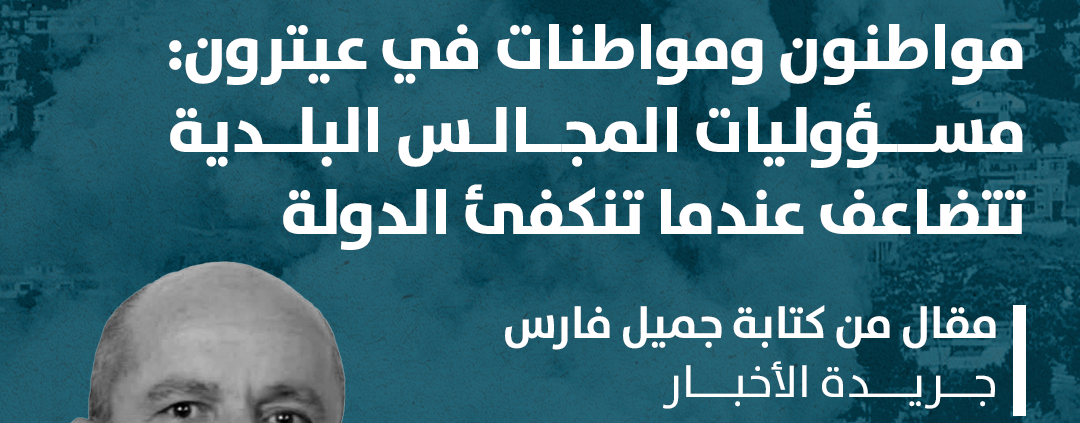جلسة نظمتها الحركة في ملتقى السفير بعنوان “كيف نصبح طرفًا مفاوضًا في الترتيبات الإقليمية؟”، والتي تحدث فيها الرفاق علي شيران، هادي حصني و ألكسي الحداد.
مقال من كتابة جميل فارس، عضو في حركة مواطنون و مواطنات في دولة
تعيش بلدة عيترون مع جاراتها من قرى الحافة الأمامية حالة من الإهمال المتعمد، بين غياب مياه الشفة وانقطاع الخدمات العامة، التي تحولت إلى خدمات خاصة لا يحصل عليها محتاجوها إلا كلّ بحسب استطاعته وموارده ووسائطه. وكأن هناك من يسعى لإفراغها حتى من القلة العائدة من أهلها! لتصبح مجرد معلم أثري خالٍ من كل أسباب الحياة!
هذا فيما سارعت الجهات المعنية إلى إطلاق عملية إزالة الركام عبر تلزيمات غير قانونية، وقبل أن يستفيق المتضررون على استحالة نيل تعويضاتهم التي تخولهم بناء مساكن أقل كلفة، أصبحوا بين مطرقة الحرب وسندان التعويضات. واستكملت نكبتهم بنهب حديد منازلهم مقابل عملية التجريف المدفوعة الأجر أصلاً عبر مجلس الجنوب، فيما يقوم بعض أعضاء المجلس البلدي بالاستثمار بما لا يجيزه القانون، وبعمليات سمسرة على حساب المنكوبين، بالإضافة إلى تدمير ملاعب رياضية نجت من الاحتلال، مع تأمين مكبات للردم على نفقة المجلس البلدي لحساب المتعهد!
إن مصير القرى الحدودية سيشبه مصير القرى السبع عما قريب إذا ما بقي الإهمال السياسي والخدماتي سيدا الموقف، الكل يرى تشابه الظروف وكأن خلافاً بدأ على هوية القرى الحدودية! وهي التي لمّح الاحتلال في بداية حرب الإسناد لجعلها منطقة عازلة حتى تحين ساعة تثبيت الترتيبات الإقليمية الجديدة، وقد يمتد الأمر على كامل جنوب الليطاني! ويترافق ذلك مع قيام أطروحات ساقطة بين الأقليات الساعية لطلب الحماية من إسرائيل، كما نرى في سوريا!
فما مصير قرى قضاء بنت جبيل بعدما شهدت في بادئ الأمر حماساً لإعادة الإعمار تجسد بتوافد جزء من أهلها ولا سيما الذين لا يملكون خيارا آخراً؟ في البداية بدا وكأن تأخر العودة مُبَرَر بانتظار إتمام العام الدراسي. لكن سرعان ما تبدد الحماس مع انعدام التعويضات للذين أنفقوا مدّخراتهم في أيام الحرب، أو ما استطاعوا إنقاذه واقتطاعه من مدّخراتهم إثر انهيار عام ٢٠١٩، وعادوا صفر اليدين ليواجهوا استحالة الوصول الى أراضيهم الزراعية بعد دمار بيوتهم، مع غياب وزارة الزراعة عن المشهد مثل باقي الوزارات.
قضية القرى الحدودية هي قضية قد لا تجد لها آذانا صاغية في زحام الانقسام والتفكك المجتمعي بعدما حلت الطائفية الممأسسة محل عقود من إهمال الإقطاع السياسي، فكانت قائدة لمراحل الخمول ثم التلاشي السياسي والاجتماعي. ذلك في بلد يحتضر، مع الرضى التام من قبل سلطته ورفض الخوض في توفير بديل عن النظام السياسي الذي تحلل بانكشاف الإفلاس المالي والتعاطي المجرم معه، وآثار ذلك على حصانة المجتمع. وبذلك بات لبنان اليوم محاصرا بإفلاس مؤسساته المدنية والعسكرية وبنزيفه البشري وبرغبات المحيط، ومحكومًا بنتائج حرب طاحنة لم تُلحظ خلالها ولا بعدها في موازنات الدولة أية اعتمادات، خاضعًا لمنطق التسول من الخارج ومستسلمًا لإملاءاته وشروطه. كل ذلك ضمن نظام المحاصصة الطائفية وبرعايته، والأهم بوزير مالية جنوبي شيعي.
ننتظر عودة المناضل جورج عبد الله، أسيرًا محررًا أمضى أكثر من 40 سنة في السجون الفرنسية بسبب عمله السياسي، فالفعل المقاوم، قبل أي شيء، هو فعل سياسي.
بعد مرور 25 سنة على حقه القانوني بأن يُخلى سبيله، وبعد أن وافق القضاء الفرنسي على ذلك، كانت السلطة السياسية قد أذعنت للضغوط الأميركية والإسرائيلية وعطّلت القرار عدة مرات. في المقابل، غابت الدولة اللبنانية تمامًا، ولم تمارس مسؤوليتها تجاه أحد أبنائها، في لحظة نحن بأمسّ الحاجة فيها إلى المناضلين الصادقين. وفي حين يحظى من يقتل عشرات آلاف الناس بالقصف والتجويع باحترام ما يسمى مجتمعا دوليا.
جورج لم يخسر سنين عمره، بل ضحّى بها من أجل مشروع سياسي آمن به، وتحرّر من خلاله، دون أن يقدّم أدنى تنازل.
تقارير القناة 24 الإسرائيلية الإخبارية، ثم كلام كمال اللبواني (المتردد على إسرائيل) ومسرحياته، ثم تنبيهات الموفد الأميركي توم برّاك وتوضيحاته وإيماءاته، ثم اللقاءات في أذربيجان، ومن ثم تجليات هذه الإشارات في معارك السويداء وفي العدوان الإسرائيلي على سوريا، والآتي… كل تلك الإشارات والأحداث تترافق مع أطروحات حول إعادة الاعتبار لعودة سوريا تحت حكم أحمد الشرع إلى الوصاية على لبنان وإلى توقّع تعديلات في الحدود بين لبنان وسوريا، عنوانها ضمّ طرابلس وعكار وبعض البقاع إلى سوريا، بالعنف.
الرابط بين هذه الإشارات والأحداث واضح بشقيه المتقاطعين تآلفًا وتعارضًا: اعتماد شرعية طائفية سنية في سوريا، والعمل الإسرائيلي المنهجي على تفتيت الدول لا بل المجتمعات المحيطة بها.
الحجج التاريخية المزعومة التي يستسهل البعض ترتادها ليست سوى غلاف لمقايضات يجري التداول بها لمواكبة المناورات التي تدور حول التوفيق بين هذين الاعتبارين: مقابل سيطرة إسرائيل على مناطق من سوريا، بدءًا من الجنوب السوري، واشتداد النزاعات الطائفية داخل سوريا بين “السنة” والطوائف الأخرى، من أكراد ودروز وعلويين وروم، وبالتالي إعادة رسم الحدود انطلاقًا من ذلك، مقابل كل ذلك، تتحكم سوريا، تعويضًا عن خسارات في جنوبها وتفلّت في مناطق الساحل، بمنفذ بحري، سنّي، عبر طرابلس. قد تبدو هذه المناورات شكلية، لكن الاعتبارات التي أدّت إلى التعبير عنها تستحق، من دون شك، التنبّه والتحذير. منطلق هذه الأطروحات إسرائيلي، سواء عبّرت عنها القناة الإسرائيلية أو نطق بها اللبواني، بينما بقيت تصريحات توم برّاك باسم الراعي الأميركي أكثر تحفّظًا وتخبّطًا.
يهمنا هنا أولًا أن نخاطب أبناء الشمال لا بل أن نتكلم باسمهم: طرابلس لم تكن يومًأ جزءًا مما سمّي مؤخّرًا سوريا. بل بقيت لقرون، أسوة بدمشق وبحلب، مركزًا لولاية عثمانية واسعة، يحدها جسر المعاملتين جنوبا وجبال أمانوس شمالًا، وتشمل سناجق حمص وحماه والسلمية وجبلة واللاذقية والحصن. مع التنظيمات العثمانية وإنشاء متصرفية جبل لبنان، ومن ثم إنشاء ولاية بيروت عام 1888، ألغيت الولاية وأصبحت طرابلس جزءًا من ولاية بيروت التي شملت كل الساحل الشرقي للمتوسط، فألحقت أجزاؤها الداخلية بولاية دمشق. لم يدم ذلك إلا قرابة ثلاثين عامًا، حتى عام 1920. ومع الانتداب الفرنسي أقيم لبنان الكبير إلى جانب إقامة خمسة كيانات فيما أصبح لاحقا سوريا. وما إن حصل استقلال لبنان وسوريا، إثر إعطاء الفرنسيين الإسكندرونة لتركيا كي لا تدخل في المحور الفاشي، حتى قامت الدولة السورية بتحوير خطوط النقل، ولا سيما سكة الحديد بين طرابلس وحمص، وبإنشاء مرفأي اللاذقية وطرطوس، حارمة طرابلس من خصائص موقعها الطبيعي ومن دورها التاريخي ومن وظيفتها الاقتصادية كمنفذ بحري للوسط السوري. هيمنة بيروت وبورجوازيتها التجارية والمالية وقصر نظرها، معطوفتان على الحرب الأهلية المجرمة وتدخلات سوريا ومنظمة التحرير، أدّت إلى تعميق فصل طرابلس ليس فقط عن جزء من محافظة الشمال وعن بيروت، وإنما أيضًا إلى تقسيمها بين واجهة غربية غنية تضم بعض أكثر اللبنانيين ثراءً، وعمق شرقي فقير مهدّد بعودة التوتّر والعنف إليه وانطلاقًا منه، إذا ما تفعّلت التدخلات المخابراتية. هذه هي الأسباب الواقعية لما يعيشه أبناء الشمال وينعكس كبحًا للطموحات فموقعًا متراجعًا ضمن نظام ائتلاف الطوائف البائس. الرد على هذا الواقع البشع لا يكون بالسير بما يتم تقديمه على أنه خلطة سحرية للتعويض عن عقود من الحرمان عبر استجلاب المحسنين الخارجيين وفتح مطار القليعات، ولا بالاستقواء بالهويات، فالهويات لا تنتج الا عنفًا، بل بلعب دور فاعل، وضروري، لطرابلس وللبنان، في تغيير مسارات الواقع التي أنتجت طرابلس بالشكل التي هي عليه، وبهكذا عمل يكون الرد الأنسب. فإعادة ربط طرابلس ببيروت عبر خط نقل سريع يعبر بينهما بنصف ساعة كفيل بتوحيد المجال اللبناني وبإرساء تكامل اقتصادي وخدمي بين أكبر مدينتين في لبنان ليصبح مجموعهما قطبًا إقليميّا وازنًا.
ويهمّنا أيضًا مخاطبة أحمد الشرع كمتولٍّ اليوم للحكم في سوريا في مرحلة خطيرة من تاريخها. نقول له إننا خبرنا في لبنان، قبل سوريا، حربًا أهلية دامت خمس عشرة سنة، وإن إنهاء الحروب ليس بالأمر اليسير، وإنهاء الحروب الأهلية أصعب وأدقّ، وإن سوريا ولبنان لم يعودا محور المشرق ونافذته، ولن يعودا كذلك تلقائيّا، وإن لهما مصالح مشتركة تضاعفها تراجع مكانتهما ومواردهما بحكم الحرب والهجرات. اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان أرسى نظام هدنة بين طوائف ممأسسة ومسلحة، واستمر خلال خمس عشرة سنة تحت وصاية ثنائية سورية-سعودية في ظلّ أحادية أميركية مطمئنّة، واستمر بعد ذلك، من دون الوصاية، بشكل اللا-دولة الطائفية، في ظل توازن هش بين أميركا وإيران، وفي خضمّ بدايات إعادة تشكّل الإقليم تحت ضغط أحادية أميركية باتت قلقة ومتوتّرة، وإصرار إيران على تثبيت شرعيتها عبر الإقليم. التغيّرات المتسارعة التي نشهدها جعلت لبنان يواجه اليوم تحدي تثبيت شرعية دولة واثقة، لا يمكن، بحكم الموروث التاريخي فيه، إلا أن تكون شرعية مدنية، والتلكؤ في اعتماد هذا الخيار يرتب خسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة. أما سوريا، فقد خضعت خلال نصف قرن لحكم قاسٍ، لم يتردد في ممارسة القمع عندما رأى نفسه مهدّدًا، وتستّر وراء شعارات أغفلت واقع المجتمع ومسارات تغيّره وتنوعه الشديد اثنيًا ولغويًا ودينيًا. والمجتمع السوري مختلف عن المجتمع اللبناني بديمغرافيته وبعلاقاته النسبية وبعلاقات ريفه بمدنه وبدرجة تجذّر المؤسسات ضمنه، ومن ضمنها المؤسسات الطائفية. نقول لأحمد الشرع إن طيّ صفحتي القمع والعنف تحدٍّ يواجهه، وكذلك التدخلات الخارجية، فالجيوش الدولية والإقليمية حاضرة بالمباشر في سوريا، أميركا وروسيا وتركيا وإسرائيل. والحلفاء ليسوا جسمًا واحدًا، كل واحد منهم يعمل لمصالحه، فكيف بالمتقاطعين ظرفيًا؟ ورهان “المكونات” على دعم خارجي هو ارتهان، خبرناها في لبنان تكرارًا، وخبرها بشار الأسد وهو يشهدها اليوم. سوريا بحاجة لشرعية واثقة وجامعة، تتعامل مع المواطنين على أساس مصالحهم الواقعية، المتلاقية منها والمتعارضة. فحذار من تكريس الطابع الطائفي الذي تبدّى في الحرب الأهلية، تحت غلاف المقولات الدينية. في ذلك خطر على سوريا ومخاطر شديدة على العلاقات بين البلدين. وليست طرابلس جزءًا تاريخيا من سوريا ولا هي “قلعة للمسلمين” بحيث يمكن استبدال مرفأي اللاذقية وطرطوس بها كما بشّر “الدكتور” المذكور، ناطقًا باسمه أو باسم مصادر وحيه، ومضيفًا صيدا لوضوح البيان. كلا مجتمعينا مصاب بتشوهات واقعية عميقة، ويجدر جعل هذه التشوهات تعوّض بعضها عن البعض بدل التستّر عنها، بعدوانية واستعلاء من قبل سوريا أو بانكفاء وتجاهل من قبل لبنان، كما حصل منذ الاستقلالين. التعامل مع الواقع لا يكون بالاستقواء بالهويات وبقدرات التأطير العشائرية ولا بالتموضع في مشاريع الآخرين. وطرابلس كفيلة بأن تشكل قطبًا لتكامل عقلاني بين لبنان وسوريا.
سوريا تؤثّر في لبنان لكن لبنان يؤثّر في سوريا أيضًا، والتأثير يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا. نحن ندعو إلى بحث جدي تتقدم فيه المصالح التي تجمع بين البلدين على الاعتبارات الموروثة من الحرب ومن المآسي ومن الأساطير ومن الدسائس، لحشد ما بقي متوافرًا من الموارد في مواجهة إعادة تشكّل للإقليم لبنان وسوريا فيه هامشيان، وبالتوازي مواجهة العمل التخريبي الممنهج الذي تقوم به إسرائيل.
مقال من كتابة آلان علم الدين نشر في جريدة الاخبار:
يرى البعض أن «السلطة» هي عبارة عن أفراد، ويركزون جهودهم على تغيير هؤلاء الأشخاص، معتبرين أن وصول مسؤولين جدد وغير فاسدين هو جوهر التغيير. أمّا البعض الآخر، فيدرك أن زعماء اليوم هم معارضو الأمس وأن «السلطة» هي نهج وليست أفرادًا، فيرون أن التغيير هو تغيير النهج، معتبرين أن تبني سياسات على قطيعة مع المنطق السائد هي جوهر التغيير، أي «الثورة» بكامل معنى الكلمة. فأين تقع لائحة «بيروت مدينتي» من هذه المعادلة؟ هل هي لائحة «ثورة» أم لائحة «سلطة»؟
– القيد الطائفي والمحاصصة الطائفية: عام 2016، اقترع حوالى 90 ألف شخص في بيروت لاختيار بلدية تهتم بشؤون أكثر من مليون شخص سجلّ قيدهم في مكان آخر.
الحلّ بسيط، وهو الاقتراع على أساس السكن لا القيد الطائفي-المناطقي، وهو خيار ديموقراطي إذ يتيح للمواطنين اختيار بلدية تهتم بشؤونهم، وخيار ثوري إذ يفرض على المرشحين تبني خطاب يتمحور حول مصالح الناس لا نسبهم الطائفي. لكن «بيروت مدينتي» رفضت تبني هذا الطرح، أي إنها، في حال نجحت في الانتخابات، لن تعمل على حلّ مشكلة عدم التمثيل وزعزعة المنطق الطائفي للانتخابات المقبلة. كما إنها تخضع للمنطق الطائفي عينه الذي أُسّس نظامنا عليه والذي ثُبّت في اتفاق الطائف: فلا «تغيير» عن عرف المناصفة، إذ نصف مرشحيها مسلمون والنصف الآخر مسيحيون، ورأس اللائحة مسلم ونائبه مسيحي. لذا، ليس من المستغرب أن يدعم اللائحة عدد من النواب الطائفيين، كياسين ياسين النائب «التغييري» الذي كان قد صرّح أنه سيقف ضد أي قانون منافٍ للشريعة الإسلامية.
– تبدية الشعارات على المشروع: يتميز زعماء الطوائف بتبني شعارات دون مشروع. فالشعار هو عنوان عريض، غالبًا ما يروق للجميع. أمّا المشروع، فهو تبني خيارات لترجمة الشعار، والخيارات، إذ تبدّي مصالح على مصالح أخرى، لا يمكن أن تروق للجميع. على سبيل المثال، دعت على مرّ العقود «القوات»، كما حزب الله، إلى تسليح الجيش (الشعار)، ولكنّ وزراءهما لم يطرحوا ميزانية لذلك ولم يحدّدوا مصدرًا لهذا الدخل ولم يطرحوا مصدرًا للسلاح (الخيارات).
ويبدو أن لائحة «بيروت مدينتي» تتّبع النهج نفسه، إذ يذكر برنامجها «دولة المواطنة المدنية» و«تفعّل وتطور التعليم والقطاع الصحي» و«العدالة الاجتماعية والبيئية»، ولكن دون تبنّي مشروع لذلك، فهي رفضت تبني الخيارات التي طرحها حزب «مواطنون ومواطنات في دولة» لترجمة هذه العناوين إلى واقع فحسب، دون تقديم خيارات أخرى. وهذا يشمل رفض الدفع نحو تعداد سكاني وهو الخطوة الأولى للنهوض الاقتصادي، فكيف نضع خطة دون معرفة عدد وواقع وخبرات المقيمين بدقّة؟ كما إنها كرّرت منطق «الخطاب المزدوج» للسلطة، إذ يذكر برنامجها أن «إسرائيل كيان عنصري عدو» في حين تتضمن اللائحة مرشحين يطرحون «السلام مع إسرائيل» كخيار واردٍ و«سهل» على حد تعبيرهم.
– التطبيع مع أصحاب المصارف: خسرت بلدية بيروت مليار دولار ابتلعها أصحاب المصارف، عدا عن عشرات المليارات الأخرى التي سرقها أصحاب المصارف من جيوب المواطنين والنقابات والمؤسسات الأخرى، لا سيما في العاصمة. لذا، لا بدّ من العمل على تحميل البنكرجيين عبء الخسائر لإنهاض المجتمع الاقتصادي. أمّا برنامج «بيروت مدينتي»، فلا يأتي إطلاقًا حتى على ذكرهم. وهذا ليس بمصادفة، إذ إن النواب «التغييريين» الداعمين للائحة عم أنفسهم من منحوا الثقة لحكومة المصارف (11 وزيراً من أصل 24 هم أعضاء في مجالس إدارات ومحامي المصارف). هذا عدا عن إعلان عدد منهم بصريح العبارة أنه يجب ألا توزّع الخسائر على البنكرجيين بل على «الدولة»، مكررين خطاب زعماء الطوائف ونهج مَن يتوقون للحلّ محلّهم.
طبعًا، لا يعني كل ما سبق أن نيّة أعضاء اللائحة عاطلة أو أنهم أشخاص سيئون. فقد يتمايزون فعلًا عن الزعماء التقليديين من الناحية الأخلاقية أو حتى المهنية. وهكذا يقدّمون خيارًا حقيقيًا لمن يريدون تغييرًا في الوجوه لا في النهج. وهنا لا بدّ من التذكير أن لا أحد من الزعماء الحاليين كان هناك حين وقع بلدنا في الحرب عام 58 أو عام 75. فاستمرار السلطة ليس استمرارًا لأشخاص سوف يُستبدلون أو يشيخون ويموتون، بل استمرار لنهج. وهذا ما يبرّر وجود لائحة تحمل مشروعًا سياسيًا ثوريًا، مشروعًا على قطيعة مع المنطق الطائفي السائد ويطرح خيارات اقتصادية حقيقية للعاصمة والمجتمع ويحمّل أصحاب المصارف عبء الخسائر، أي «لائحة لدولة».
تخوض حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» الاستحقاق البلدي، بمفاهيم ومعايير، مختلفة جذرياً عن السائد، منطلقةً من أنّه استحقاق سياسي صرف، لا عائلي ولا إنمائي بالمعنى الضيّق للكلمة، وحكماً لا تحكمه الاعتبارات الطائفية حيث البلدات مختلطة. هو سياسي، بمعنى اتصاله بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يتبناها المجلس البلدي، وعلى أساسها يضع مشاريعه المُفترض أن تتماشى وحركة المقيمين في البلدة أو المدينة، وأن تطاول حق السكن، والعمل، والطبابة، والنقل المشترك، وإشعار الناس بالطمأنينة وتثبيتهم في بلداتهم وتالياً في وطنهم.
الطرح قد يبدو غير مألوف. وهو كذلك، عن قصد، لأن الحركة تقدّمه كـ«بديلٍ إجرائي عن النظام السياسي، المعطّل إجرائياً». هذا النظام الذي يهدد ببقائه تبديد موارد المجتمع. ولأن البلديات ساحة من ساحات النظام المعطّل، وجزء من البنيان المترهّل للدولة، سعت الحركة إلى أن تُظهر «البديل» انطلاقاً منها.
بالانطلاق من التعريف، يرفض الأمين العام للحركة شربل نحاس، فصل البلدية عن السياسة، لما في ذلك من إراحة لأحزاب السلطة، التي «تلجأ إلى اللعب على العبارات بدهاءٍ ما بين سياسي وعائلي، للهروب من النزاعات التي تنشأ بين العائلات نفسها، على خلفية الترشيحات البلدية، تفادياً لخسارة قسمٍ من العائلة إن تمّ تبنّي دعم أحد مرشحيها على حساب الآخر». وبالتالي فإن سطوة الأحزاب ضمن الطائفة الواحدة، تفترض برأيه، «عدم أسر الحزب ضمن حسابات العائلات».
أما صيانة تعايش الطوائف، حيث تتلاقى، كما هو الحال في بيروت، فتفترض «ألا تكون هناك نزاعات بينها». لذلك، «اجتمعت كلّ الأحزاب المُتخاصمة في لائحة واحدة في بيروت، تحت مبرّر أن الاستحقاق بلدي ومحلي وإنمائي، لا سياسي». بهذا المعنى، تقول أحزاب السلطة إنّ «السياسة هي التهديد، والقلق، والخوف، وكل ما يمكن لمّه دون الوصول إلى العنف الطائفي نسميه عائلياً لا سياسياً».
ويسأل نحّاس: «أين العائلات التي يتلطّون خلفها، بينما السكان الفعليون لا ينتخبون ولا يراقبون بل يدفعون الضرائب فقط، والناخبون المهتمون أقصى اهتمامهم الوصول إلى البلدية من باب الوجاهة العائلية، وتزعّم البلدات والمناطق». وعليه فإن «خوض الانتخابات البلدية على أنّها شأن عائلي محلي، هو مشاركة في تعميق العجز الذي تسببت به أحزاب السلطة، ولا يجوز أن يكون مناسبة للعبة الوجاهات البائسة، وإنكار ما وصلنا إليه، من واقع مرير».
لماذا اختيار بيروت وطرابلس وصيدا وعيترون؟
اختارت «مواطنون ومواطنات» ثلاث مدن رئيسية، وبلدة من بلدات الحافة الأمامية جنوباً، لتخوض فيها الانتخابات البلدية. وعدا كون العمل في المدن يفتح نافذة أوسع للعمل السياسي، فإن لكل منطقة رمزية في اختيارها.
في بيروت، تخوض الحركة الاستحقاق بلائحة «عاصمة لدولة»، مؤلّفة من 15 مرشحاً. فجاء الاختيار، كون بيروت «مدينة مقطّعة فقدت دورها الاستقطابي الإقليمي، وبات الاستتباع والتسوّل مستحكميْن بكل أوجه الاقتصاد والسياسة والمجتمع. مدينة مجزّأة طائفياً، ضمنها أولاً، ومع ضواحيها. إضافة إلى هجرة أهالي بيروت، باتجاه ضواحيها، نتيجة التشوه الاقتصادي، وتعمّق الفروقات الطبقية، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات».
ورفضاً لدعوات المناصفة والتقسيم، أعلنت «حركة مواطنون ومواطنات» لائحة غير مكتملة من 15 مرشحاً، دون مراعاة للاعتبارات الطائفية، بين السنّة والشيعة والمسيحيين، التي حكمت تأليف لائحة الأحزاب التقليدية واسمها «بيروت بتجمعنا»، واصفةً إياها بأنها «تجديد للنظام الموروث من الحرب، في بيروت التي لا تجمع أحداً اليوم، سوى أحزاب تريد لملمة الانقسام الطائفي بمسمى عائلي، بعيداً عن البرامج وهموم أهل المدينة»، وأنها «اجتماع العجز في البلدية، كما هو حال اجتماع العجز في الحكومات المتعاقبة». وعن عدم التحالف، مع لائحة «بيروت مدينتي»، اعتبرت الحركة، أن «التغييريين ارتضوا شروط اللعبة، بتشكيلهم لائحة ترعى الهواجس الطائفية، بقولهم نحترم قواعد اللعبة لكننا أفضل».
في ما يخص طرابلس، حيث خاض مرشّح الحركة مصباح رجب الانتخابات أمس، ضمن لائحة «الفيحاء»، جاء الاختيار، نتيجة انفصال طرابلس شبه الكامل عن بيروت، وهو انفصال بين أهم قطبين مَدينيين. والانفصال الثاني عن الداخل السوري الطبيعي، بينما التطورات الأمنية في الداخل السوري تنعكس ضمن المدينة وحولها، وتراجع الدور القطبي لطرابلس، والمناطق التابعة، إضافة إلى الفرز الطبقي داخل المدينة بين شرق البولفار وغربه. واعتبرت الحركة أنّ هذا الوضع المركّب يعرّض طرابلس ومحيطها لمخاطر جدية لا تقتصر على الوضع المعيشي والاقتصادي.
أما اختيار صيدا، لأنها بوصف الحركة «مدينة منغلقة، بحكم وقوعها بين مناطق تُعتبر طائفياً منفصلة عنها، أي الشوف وجزين وجبل عامل، فتحولت صيدا إلى ممر للجنوب بشكل عام، وبوابة إلى بيروت، وبحكم هذا الانزواء، تحوّل أفق الحراك السياسي من مختلف أطرافها فبات محصوراً في النطاق البلدي».
في عيترون، تجري «الحركة» مفاوضات قبيل إطلاق اللائحة. لكنّ القرار بخوض المعركة، في الأصل نابع، من رمزية البلدة، التي تعبّر عن «مآسي البلد شأنها شأن كل بلدات الحافة الأمامية جنوباً»، بصفتها «شاهدة على العدوانية الصهيونية، وقدّمت تضحيات جسيمة، ومعاناته داخلياً بحكم تمزّقه الاجتماعي والسياسي». خوض الاستحقاق بالنسبة إلى الحركة هو «اعتراض على منطق أن حزب الله ومن خلفه البيئة الشيعية مسؤولون عن تحمل تبعات قرار خوض الحرب»، وبالتوازي مع معارضة هذا الجدار المبني داخلياً بوجه الثنائي، تعتبر الحركة أن «الثنائي الشيعي يبني جداراً يحاصر به نفسه، عبر محاولاته إنجاح البلديات جنوباً بالتزكية، من أجل تحصين الطائفة».
الرؤية والبرنامج
أعلنت «مواطنون ومواطنات» عن برنامجها للعمل البلدي، ويتدرّج من إعادة تطبيق القانون الذي يرعى عمل البلديات وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تساهم في مكافحة الهجرة.
في القانون، يتحدث البرنامج عن التزام البلديات بتنظيم سجلّ خاص بها، يتضمّن أعداد وأسماء شاغلي كل عقار، من لبنانيين وغير لبنانيين، والمؤسسات والعاملين فيها. وأن يتم تحديث السجلّ بشكل دوري، أي أن على البلدية القيام بتعداد المقيمين والعاملين ضمن نطاقها، وإشراك المقيمين في نطاقها، سواء كانوا مسجّلين أو لا، في أنشطتها استشارياً، وجعل اجتماعاتها ومقرراتها وماليتها علنية. وهي نقطة انطلاق لتعترف بأن أعداداً كبيرة من السكان ليسوا من الناخبين، ولتتمكّن من فهم حاجاتهم وتخطيط المشاريع على أساسها.
على مستوى اتحادات البلديات، يطرح البرنامج، التخلّص من الاتحادات بشكلها الحالي، حيث هي في غالبيتها ترجمة لهيمنات سياسية، ولا علاقة لها بمجالات حياة السكان وتنقّلهم. فمثلاً، كيف تُخطط مشاريع لبيروت، منفصلة عن المناطق، أي الضواحي، المرتبطة بها عضوياً، من خلال اتحادات مفروزة طائفياً، كاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، واتحاد بلديات المتن، طارحةً اتحاد بلديات واحداً لبيروت الكبرى يضم المناطق الواقعة بين صيدا وجبيل، انطلاقاً من أن السكان في ضواحي العاصمة، هم مربوطون بها، على مستوى وظائفهم، ودراستهم وطبابتهم، والمشاريع يجب أن تراعي احتياجاتهم وحركة تنقّلهم من وإلى بيروت الإدارية.
وإلى جانب الإشارة، إلى أن قانون «الرسوم والعلاوات البلدية» يحدد قيم الرسوم بالليرة التي فقدت أي قيمة، ما يستدعي تعديله وفق معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار، يضيء البرنامج، على صلاحيات عادةً تتجنّب البلديات ممارستها، أو تحمّل مسؤوليتها، مثل السعي إلى تأمين حق السكن، عبر اشتراط أن أي بناء سيُشيّد على أراضٍ تابعة للبلدية، يجب أن يضمّ عدداً من الشقق السكنية الصغيرة المتدنية الكلفة، بغية بيعها أو تأجيرها بأسعارٍ معقولة تناسب الشباب. كما السعي إلى تأمين النقل المشترك الآمن، بين بيروت والمدن البعيدة مثل طرابلس، عبر مشاريع ترعاها البلديتان.
«مواطنون ومواطنات» في عيترون
مقال من كتابة جميل فارس عضو في حركة مواطنون و مواطنات في دولة نشر في جريدة الأخبار.
تقول الرواية الشعبية إن كلمة عيترون تطوّرت من «عثرون» التي تعثّرت بكارثة طبيعية بعدما أسقطها زلزال مدمّر، ويقول أحد معلميها إنها اختصار لكلمتي «عَيت» و«رون» من لغة قديمة، وتعني الرائحة الطيبة.
أما بعض مثقفيها فيعتبرون أنها مشتقّة من اسم إلهة الحب والجمال لحضارة عابرة، وهو التفسير الأقرب إلى قلبي، رغم أن عيترون لم ترَ من الحب إلا القدر اليسير منذ نكبة فلسطين.
غابت الدولة عن قريتي، فتحمّل أبناؤها عبء النهوض التعليمي والثقافي، على سِماط الفقر بعزيمتهم، رغم الاحتلال وشتات أبنائها بين الهجرتين الداخلية والخارجية، حتى 25 أيار عام 2000 واندحار الاحتلال.
لكنّ النظام اللبناني التزم، رغم التحرير، عُهدة الإهمال، وتحوّل كل ما له تماس بإنماء البشر إلى جوائز ترضية، وطغت العلاقات الشخصية على المؤسسات لتزيد من عزلة المزارعين والمعلمين والكادحين وبؤسهم، ولتُقفر القرية مرة جديدة، ويهاجر أبناؤها بحثاً عن فرص عملٍ تليق بكفاءاتهم التعليمية، أسوة بكل الشباب اللبناني الذي تحوّل إلى مغانم مدفوعة الكلفة للدول المستوردة، ومصدر عملة صعبة ينضب ورودها على مر الوقت إلى الدولة المُصدِّرة. وتحوّل الاستحقاق البلدي إلى تقليد عائلي لمن تفرّغ له، بدل أن يكون تكليفاً ومسؤولية لمن يتهيّأ له. هو واقع مؤسف رغم عِظم التضحيات، أن يكافئ المقاومةَ المستمرة منذ عقود جحودُ سلطة الطوائف!
لذلك، ندخل كحزب «مواطنون ومواطنات في دولة» الاستحقاق البلدي في عيترون، لنكون على مستوى المسؤولية، في ظل حرب إسرائيلية تتبدّل دون أن تنتهي، لاستعادة مفهوم العمل البلدي وإعادة تعريفه في الواجبات كما في الحقوق.
حقوق ممنوعة عن المواطنين وعن بلديتهم، لتقاعس رؤسائها منذ عقود وارتضائهم موبقات السلطة وتعطّلها، مسؤوليات المجالس البلدية تتضاعف عندما تنكفئ الدولة وتتغاضى عن حاجات الناس بعد ست سنوات من إفلاس مدوٍّ.
هي قضية مسؤوليات قبل أن تكون قضية صلاحيات، وصلاحيات المجالس المحلية تقارب صلاحيات مجلس وزراء.
عيترون رمز لمعاناة لبنان كله، خارجياً مع عدو محتلّ، وداخلياً بحكم الإفلاس والهجرات وتمزّق البلد الاجتماعي والسياسي وفق الخطوط الطائفية.
وتعاني القرية، من الحرب وآثارها مرتين، بالتضحيات الغالية التي قدّمتها، وبارتضاء أن مواجهة المشروع الصهيوني مسألة تخص الطائفة، معزّزة بذلك الاعتبار السائد لدى كثيرين، بأن الشيعة هم المسؤولون عما حلّ بهم.
وترتبط أسباب المعاناة الخارجية بالداخلية عندما نرى أن إسرائيل تعاملت مع المجتمع اللبناني انطلاقاً من المنطق الطائفي الذي يتعامل به هذا المجتمع مع ذاته، فاستهدفت «المناطق الشيعية»، وحتى الأحياء والأبنية والشقق التي يسكنها شيعة خارج تلك المناطق.
عندما يجتمع حزب الله وحركة أمل على أولوية تحصين الطائفة، يحصل تقوقع إضافي، وتصبح الطائفة سجناً وليس حصناً، ما يُسهل على إسرائيل تنفيذ استراتيجيتها المنظّمة لتفتيت المجتمعات المحيطة.
نعمل نحن من خارج النظام الطائفي، فنحمل الطرح والخطاب نفسيهما في كل المناطق، لنفكّ الأسر الطائفي وقيوده ونواجه المشروع الصهيوني في أساسه، كطرح طائفي عنصري ديني.
دفعنا، نحن أهل الجنوب، في هذه الحرب، تكاليف اقتصار المقاومة على طائفة ومنطقة معينة، وتكاليف ارتضاء نظام هدنة بين طوائف راهن كل منها على طرف خارجي وباتت مرتهنة لحساباته، من أميركا إلى إيران، نظام بدّد الموارد وعطّل القرارات وحوّل البلد إلى متسوّل، ما يريح الاحتلال ويساعده على تعزيز الانقسام ويسهّل عمليات الابتزاز حتى في مرحلة الإعمار.
إعلاء راية التزكية ضمن الطائفة يكرّس مفاعيل العجز والانقسام في لبنان ويعزّز طموحات إسرائيل بمناصرة طوائف بوجه أخرى كما يجري في سوريا اليوم. وفي هذا السياق، تصبح إعادة الإعمار أكثر من مجرد إعادة بناء حجر؛ إنها إعادة تنظيم للحياة، وإعادة تنظيم للمواجهة مع العدو الصهيوني، خصوصاً في الجنوب، لا بل انطلاقاً من الجنوب نحو الوطن كله.